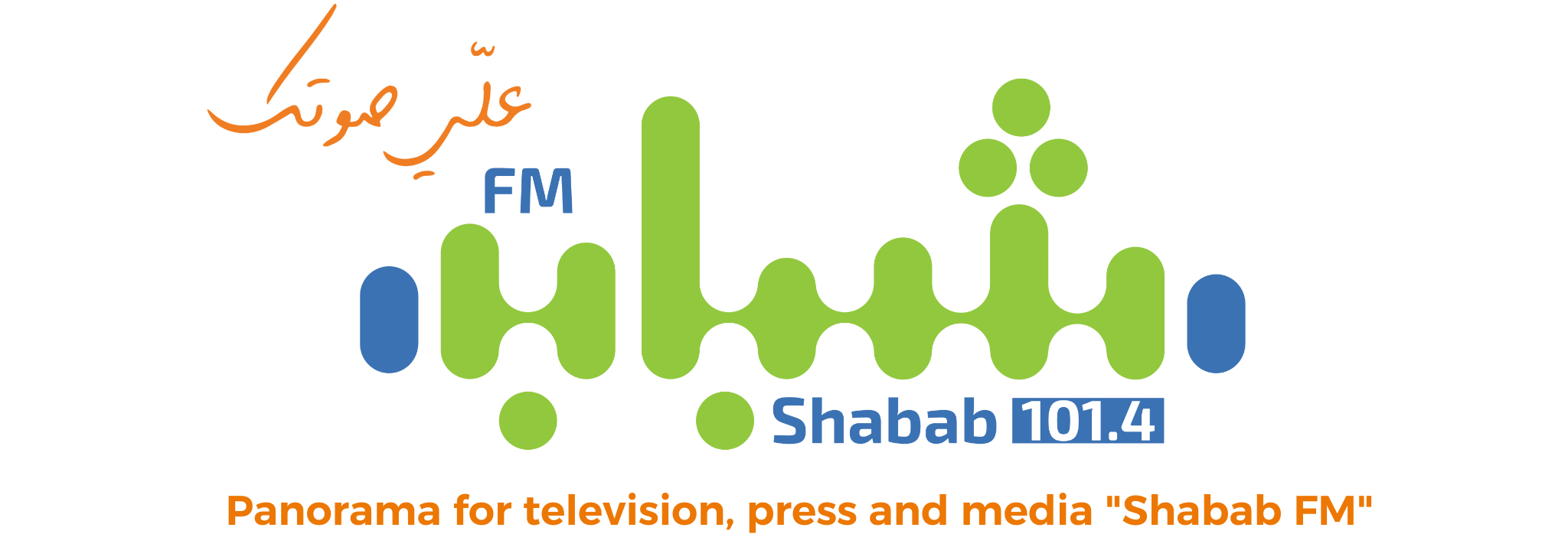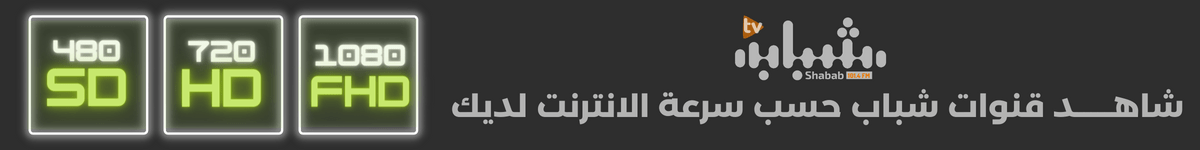على غرار النكبة الفلسطينية، فإن فوبيا فلسطين – الخوف من فلسطين وكل ما هو فلسطيني – لها جذور تاريخية عميقة في الإعلام السائد في الغرب، بما في ذلك كندا.
هذه الظاهرة لم تبدأ في السابع أو الثامن أو السادس من أكتوبر، بل استمرت لعقود طويلة. على مدى أكثر من 76 عاماً، كان التقديم العادل لما يسمى «النزاع» الإسرائيلي الفلسطيني يعني إلى حد كبير تجاهل، بل تبرير، الفظائع المنظمة كضم الأراضي، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية للرجال والنساء والأطفال، التي عانى منها الفلسطينيون. اليوم، قائمة الفظائع الممنهجة الوحشية التي يعاني منها الفلسطينيون العُزل تحت الاحتلال الاستيطاني غير القانوني والفصل العنصري الإسرائيلي طويلة ولا تنتهي.
في الغرب، كان معنى «الحياد» هو تعزيز رواية المعتدي كخطاب موثوق يلجأ إليه في أوقات الاضطراب والفوضى.
منحت إسرائيل صلاحية القيام بدور المدّعي، والقاضي، وهيئة المحلّفين على الشعب المحتل والمضطهد. حتى عندما تُضبط إسرائيل متلبسة، يفضلها الغرب لدور المحقق في جرائمها.
أمثلة حديثة، مثل اغتيال الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة والناشطة الأميركية التركية أيشنور إزجي إيجي، تمثل تذكيراً مأساوياً بذلك الظلم والإفلات من العقاب. استهدفت إسرائيل السيدتين الشجاعتين كلتيهما بدمٍ بارد في وضح النهار وأمام العديد من الشهود، ومع ذلك، لم يُحاسب أحد على جرائم القتل المفضوحة هذه.
لماذا يمر هذا الانعدام الفاضح للمسؤولية دون مراجعته؟ يبدو أن الإجابة تكمن في قيود الإعلام السائد.
عندما يتعلق الأمر بفلسطين، وفي محاولة لتجنّب ردود الفعل والعواقب، أفاد عدد لا يحصى من الصحافيين والمنتجين والمراسلين بأنهم تعرضوا لضغوط للالتزام بـ»إرشادات» معينة والامتناع عن مناقشة مواضيع معينة أو استضافة ضيوف ممنوعين «القائمة السوداء» يمكن أن يتحدوا الوضع الراهن.
لم يُمنح الفلسطينيون مكانة متساوية في الإعلام الغربي، لا في حقوقهم، ولا طموحاتهم، ولا حتى في إنسانيتهم. يتم تصويرهم إما كأشرار أو يتم اختزالهم إلى مجرد حالات تستدعي الشفقة، ما جعلهم يعانون عقوداً من الإسكات والتهميش، وتجريدهم من إنسانيتهم، ومعاداة الفلسطينية.
بعد السابع من أكتوبر، كرّس الإعلام الغربي السائد نفسه لدعم حليفه الثابت.
خصصت شبكات التلفزيون بثاً مباشراً لمدة أسبوع تقريباً، حتى لم يعد هناك أي معلومات جديدة عن الضحايا الإسرائيليين. تمت تغطية كل شيء، بما في ذلك أكوام من الدعاية الإسرائيلية والتضليل الذي اتضح أنه صُمم لتبرير نية الإبادة الجماعية التي كانت على وشك أن تحل بالسكان الفلسطينيين العزل.
سكان محاصرون بالأصل، ومعذبون ومنسيون من قِبل «العالم الحر» منذ ما يقرب من عقدين في أكبر سجن مفتوح في العالم: غزة.
تم إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل في السابع من أكتوبر – ليس من أجل «الأمن» أو «الدفاع عن النفس»، بل من أجل الانتقام.
تبنّى «العالم الحر» قناعة إسرائيل بأن رفاهية الإسرائيليين تعتمد على زوال الفلسطينيين، والأهم من ذلك أن حياة الفلسطينيين أقل قيمة بكثير من حياة الإسرائيليين.
ومع تحول الأيام إلى أسابيع ثم أشهر، لم يجد معظم وكالات الإعلام الغربية ضرورة لإظهار الحقيقة لشعوبها: أطفال مقطوعة رؤوسهم، عمليات بتر تُنفَّذ دون تخدير على الكبار والصغار، جثث معلقة من مبانٍ تعرضت للقصف الشامل، أطفال ماتوا جوعاً، وجثث في الشوارع تلتهمها الحيوانات الضالة. لماذا؟ ادّعى بعض الصحافيين أن السبب هو أن الفيديوهات القادمة من غزة لا يمكن «التحقق منها»!
حياة جميع المدنيين مهمة، وفقدان أي مدني من أي جنسية هو مأساة. ومع ذلك، أصبح من الواضح أن الإعلام الغربي لم يرَ من المناسب أو الضروري أن يقوم بالتغطية الحية عندما يتعلق الأمر بالأعمال التحريضية المروّعة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في الأيام والأسابيع والأشهر التي تلت ذلك.
لم يكن هناك اهتمام بإظهار الحقيقة الكاملة حول الجرائم الإسرائيلية المتعمّدة والمنظمة، حتى عندما كان المسؤولون الإسرائيليون والقوات المحتلة وامتدادهم الإرهابي (المستوطنون) يوثقون بفخر ارتكاب هذه الجرائم.
في الواقع، لم تُخفِ إسرائيل نيتها منع العالم من مشاهدة الحقيقة مباشرة. تم طرد الصحافيين الدوليين من غزة، وتم ذبح الصحافيين الفلسطينيين بدم بارد – 182 صحافياً وما زال العدد في ازدياد – وهي حقيقة موثقة لم يتم التصدي لها أو ذكرها في هذا المُناخ الإعلامي الغربي القائم على «نزاهة انتقائية».
«استثناء فلسطين» تشكل نتيجة الرفض الجوهري من قبل الغرب وديمقراطياته الليبرالية لتطبيق القيم والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان على فلسطين وشعبها.
تجد هذا «الاستثناء» في تطبيق القوانين الدولية، وقوانين حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وتنفيذ «النظام الدولي القائم على القواعد».
يمكن رؤية شهادة مروّعة على «الاستثناء الفلسطيني» في تخصيص مصطلح «الإرهاب» لقتل الإسرائيليين، بينما يُنظر إلى مجازر الفلسطينيين كأضرار جانبية «حتمية» في سياق «الدفاع عن النفس» و»الأمن» الإسرائيلي. كان القلق الوحيد هو: كم من الفلسطينيين يُسمح لهم بالموت لتحقيق الهدف «المبرر» لإسرائيل؟
مرّ أكثر من عام، ولا يزال السؤال قائماً: كم يكفي لإشباع هذا العطش للانتقام؟ كم يلزم من الشهداء كي يتحرك «العالم الحر» لوضع حد لهذا الظلم البشع؟
حتى السابع من أكتوبر، وبعد أكثر من عامين على خدمتي كسفيرة لفلسطين في كندا – حيث كنت مُهمَلة تماماً من قبل الإعلام السائد – فوجئت بوابل من طلبات المقابلات، ولكن مع نمط مزعج للغاية. «هل تدينين؟» كان هذا السؤال يطغى على الدم الفلسطيني المتناثر على الجدران والجثث الفلسطينية الملقاة على الطرقات.
كان سؤالاً يغسل يد إسرائيل من تجويع الأطفال حتى الموت، ومن اختطاف الأسرى واغتصابهم وتعذيبهم حتى آخر أنفاسهم.
كان يُبرر هدم المدارس والجامعات والمستشفيات والكنائس والمساجد والملاجئ والمخابز.
كان يُعطي عذراً لاستخدام إسرائيل للماء والطعام والدواء كأسلحة للإبادة الجماعية.
«هل تدينين؟» سؤال هدفه إلقاء اللوم على الضحية، «الشعب الفلسطيني»، دون أي اعتبار لألمهم ومعاناتهم ويأسهم بسبب هويتهم ومن هو مضطهدهم، مبرراً الإبادة الجماعية التي تُرتكب ضدهم.
قد تتساءلون: لماذا؟ إنه سؤال بسيط إجابته بنعم أو لا. حسناً، بعد أكثر من 400 يوم.
بعد أن ذُبح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وما زال آلاف آخرون تحت الأنقاض، بعد أكثر من عام من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل على الهواء مباشرة. بعد عشرات التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحاكم الدولية التي أدانت الإبادة الجماعية وأفعال إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وطالبت بوقف هذه الفظائع. وبعد أن خرج مئات الملايين في مسيرات وهتفوا ضد الظلم، لم يُطرح ولو مرة واحدة على أي سفير إسرائيلي سؤال: «هل تدين؟»
فلسطين كلمة قد تكلفك الكثير عند استخدامها في الغرب. إذا كنت تعمل في قطاع الإعلام أو الحكومة أو حتى في قطاع التعليم، عليك أن تكون حذراً جداً وأن تعرف بالضبط ما يمكنك، والأهم، ما لا يمكنك قوله عند مناقشة «النزاع».
على رأس قائمة المحظورات تأتي كلمة فلسطين.
إنها «الضفة الغربية وغزة»، إنها «إسرائيل والفلسطينيون»، إنها «الأراضي الفلسطينية».
هذه هي الصفات المقبولة لوصف فلسطين في الديمقراطيات الليبرالية التي تؤكد دعمها لحل الدولتين، ولكن المثير للاهتمام، أنها لم تستطع النطق إلا باسم دولة واحدة فقط!
إذاً، لماذا يعاني الإعلام الغربي من فوبيا فلسطين؟
لأن أفعال المُضطهِد تعتمد على روايات تُجرد ضحاياه من إنسانيتهم، وتصورهم كتهديدات ومعتدين لا يستحقون التعاطف.
هذه الرواية لا تبرر القمع فحسب، بل تعفي أيضاً المتواطئين الذين يدعمونه ويحمونه. إضفاء الطابع الإنساني على المقموعين يستدعي بالضرورة مساءلة القامع، ما لا يترك أي عذر لدعم الطاغية ضد ضحاياه.
الإعلام الغربي يعاني من فوبيا فلسطين لأنه لا يريد أن يظهر الألم والصمود الذي يرفرف به العلم الفلسطيني بفخر. يرفض تكريم الكوفية الفلسطينية لأنها ترمز إلى ارتباط الفلسطينيين بأرضهم التاريخية، ارتباطاً كان وسيظل إلى الأبد.
ينكر التمثيل الحقيقي لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة وحقوق الإنسان الأساسية، لأن هذا النضال يحمل تذكيراً صارخاً بالفشل، والتحيّز، والمعايير المزدوجة التي يتبناها «العالم الحر»، وقيمه ومبادئه.
الإعلام الغربي يعاني من فوبيا فلسطين لأن فلسطين هي معركة الحقيقة.
- صحيفة الأيام
- ي.ك