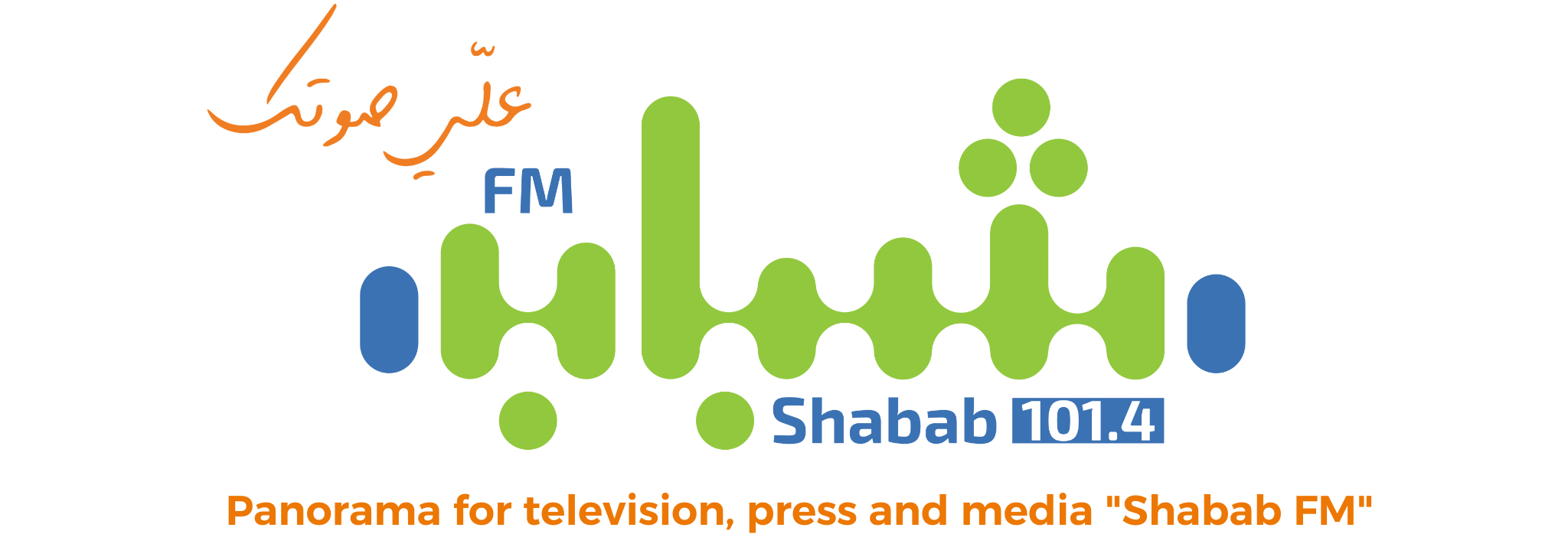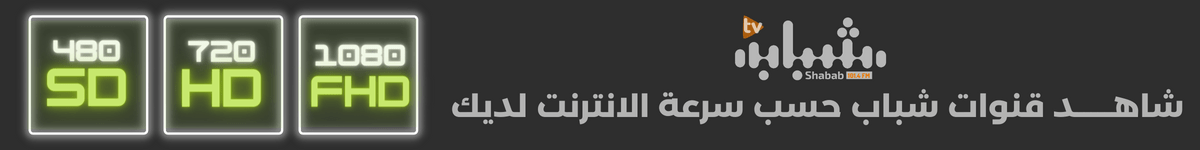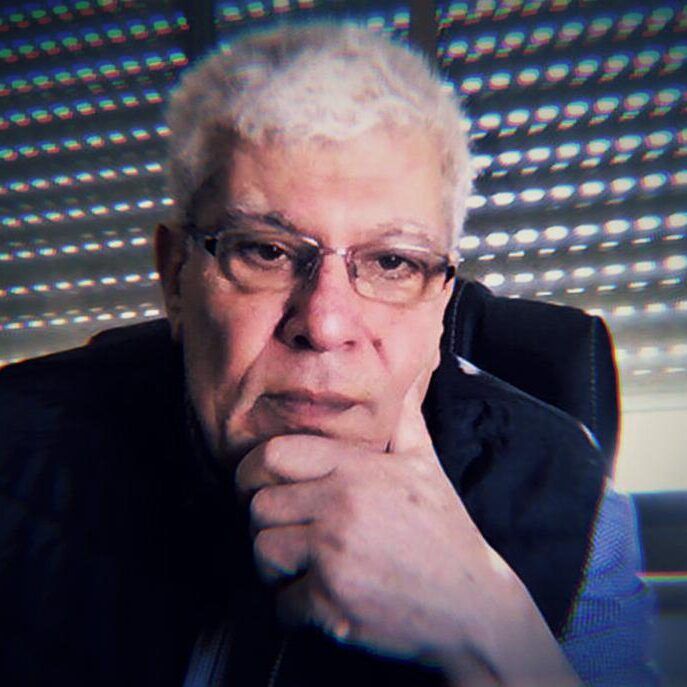لا معنى للكلام عن حروب العشرية الثالثة بعيداً عن دونالد ترامب، ليس لأن ولايته الثانية ستغطي النصف الثاني من العقد الحالي وحسب (2025 – 2029) ولكن لأن ولايته الأولى (2016 – 2020) تركت بصمة واضحة على نصفه الأوّل، أيضاً.
ثمة مداخل مختلفة للكلام عن ترامب، الذي تمثّل عودته إلى سدة الحكم حدثاً مفصلياً في تاريخ الولايات المتحدة والعالم.
ولا يبدو من السابق لأوانه الحكم على الحدث المقصود بالكارثي. سنفسّر معنى الكارثة بالنسبة للأميركيين والعالم، في معالجات لاحقة. ولكننا نحتاج، اليوم، للتفكير في التداعيات المحتملة للكارثة المعنية على المسألة الفلسطينية، والصراع في فلسطين وعليها، وبشكل أكثر تحديداً على النهايات المحتملة للحرب الحالية. فهذا هو موضوع الساعة، كما يُقال.
وقد أضيفت في الأيام القليلة الماضية تحليلات وتسريبات كثيرة بشأن سياسات أميركية مختلفة تجاه المسألة الفلسطينية، في عهد الإدارة الترامبية الجديدة.
ويمكن إضافة ما قيل إلى تحليلات وتسريبات كثيرة (إسرائيلية وإبراهيمية) على مدار أشهر حاسمة سبقت يوم الانتخابات، وكان أسوأها على الإطلاق أن ترامب «لا يحب» الحروب، وسيعمل على إنهائها بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض. وهي الذريعة نفسها التي استخدمت لإقناع مواطنين أميركيين من أصول عربية، وبلدان إسلامية بالتصويت لترامب.
وإذا شئنا الكلام بطريقة ما قل ودل، فلنقل إن سياسات ترامب في ولايته الثانية هي سياسات ترامب في ولايته الأولى، وهي ما عبّر عنه في مناسبات مختلفة على مدار أربع سنوات مضت قضاها خارج البيت الأبيض.
بمعنى أكثر وضوحاً، وبقدر ما يتعلّق الأمر بالمسألة الفلسطينية: لا يوجد على الطاولة سوى السلام الإبراهيمي، بما يعني من تحالفات عسكرية تحت الراية الإسرائيلية (سمها الناتو العربي، أو ما شئت) وشراكة اقتصادية، و»تصفية» للمسألة الفلسطينية (التصفية مستحيلة، ولكن هذا موضوع آخر). والصحيح أن الحرب الحالية تمثّل وسيلة إيضاح مثالية فعلاً لما لهذا كله من دلالات وتداعيات مباشرة وبعيدة المدى.
ومع هذا في الذهن، فلا ينبغي استبعاد الإخراج المسرحي، والتمثيلات الدرامية، التي يعبدها مريض بنفسه، ويحتاجها شركاء على درجات متفاوتة من مهارات إخراج الأرنب من القبعة، وقدرات متفاوتة في إطلاق أسراب مختلفة من الذباب الإلكتروني، وتجنيد محللين وطباخي أخبار على الشاشات اللامعة للفضائيات. ومع ذلك، وعلى الرغم منه، فإن المقياس الفعلي لحقيقة ما يجري على الأرض، وبصرف النظر عمّا تسمع من كلام في نشرة الأخبار، هو بقاء أو انسحاب الإسرائيليين من غزة، وبقاء أو إخراج ورقة ضم أجزاء من الضفة الغربية من التداول.
ومع هذا في الذهن، أيضاً، من غير المفيد قياس السياسات الترامبية بمدى تمثيلها أو تطابقها مع كلام ترامب نفسه، أو كلام مساعديه، وكلام الإبراهيميين، ودكتاتوريات الحواضر، بل يمكن العثور على مؤشرات أكثر إيحاء، وأشد دلالة، في كلام بنيامين نتنياهو، في المنطوق والمسكوت عنه على حد سواء.
ولنلاحظ، هنا، أن كلامه عن «النصر المؤزر» يندرج في باب المسكوت عنه، ليس لعجزه عن رؤية ما يريد، بل إما تفادياً لإجهاض ما يريد إذا كشف عنه قبل الأوان، أو خشية ألا ينجح في الحصول على ما يكفي من أوراق القوّة في الميدان، والإقليم، والعالم.
على أي حال، وفي سياق كهذا، يبدو أن رد الاعتبار الذي يتوّج طموح نتنياهو، بعد اللطمة الهائلة التي كادت تطيح به يوم السابع من تشرين الأوّل (أكتوبر) 2023، يشمل البقاء في غزة (كلها، أو في أجزاء منها، مع سيطرة أمنية على الكل) وضم أجزاء من الضفة الغربية، و»تصفية» قضية اللاجئين، والتحالف العسكري والشراكة الاقتصادية مع الإبراهيميين، إضافة إلى القضاء على تهديد حزب الله في جنوب لبنان، وتقليم أظافر إيران النووية، وأذرعها العسكرية الميليشياوية في الإقليم (سحق التهديد الشيعي في الشرق الأوسط، حسب مفردات وإيحاءات تكررت في كلامه).
أن يتمكّن نتنياهو من تحقيق رد الاعتبار بهذه الطريقة، وبهذا الحجم والقدر من الطموح، سؤال من نوع آخر. ولكن في مجرد مراوحة سؤال كهذا في الواقع، ما يعني أن السياسات الترامبية لن تعدو (في أكثر السيناريوهات سوءا) أن تكون نوعاً من الخداع والدراما الرخيصة، ولن تتجلى (في أفضلها) إلا بوصفها نوعاً من التكّيف والتكييف.
المهم: لن تخلو تداعيات اليوم الأوّل لترامب في البيت الأبيض من المشهدية والدراما.
وهذا ناجم عن مرضه بنفسه، إلى حد بعيد. سيكون لدينا الكثير من الوقت لتحليل الظاهرة الترامبية، وتداعياته المباشرة على حروب ما تبقى من العشرية الثالثة. وما يعنينا، الآن، وبقدر ما يتعلّق الأمر بنا، أن ترامب لا يحب أحداً، ولا يعادي أحداً. فمعياره الوحيد هو الكسب بالمعاني المادية والشخصية الضيّقة.
لذا، وعلى الرغم من علاقاته الجيّدة مع الإبراهيميين (إلى حد يبرر إحساس البعض بأنه في جيوبهم) إلا أن إسرائيل، وامتداداتها الأميركية، أو أميركا وامتداداتها الإسرائيلية، إذا شئت، هما رهانه الحقيقي، وبوليصة التأمين، التي حرص، وما زال، على الحفاظ عليها، والاحتفاظ بها، كما يليق بتاجر عقارات، في وجه عاديات الزمن.
في سياق كهذا، وبناء عليه، فإن مفاتيح السياسة في يد القوى التي أنجبته وأوصلته إلى البيت الأبيض، ومكّنته من الصمود على مدار أربع سنوات من الملاحقات القضائية، كما مكّنته من العودة الظافرة إلى سدة الحكم، أما هو فيقول كثيراً من الكلام الفاضي، مع قناعة دائمة بأن ورقة السياسة الأقوى هي «الخوف»، كما قال لبوب وودورد قبل سنوات، وجعلها الأخير عنواناً لكتاب عن الولاية الترامبية الأولى في البيت الأبيض.
- صحيفة الأيام
- ي.ك